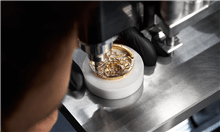ما بعد كورونا: حقائق عن عالم جديد
ما بعد كورونا: حقائق عن عالم جديد
-
 سليمان عوده
سليمان عوده
ولد تفشي فيروس كورونا أزمة صحية عالمية لم تشهد الأجيال الحية مثيلًا لها، والنتائج التي ستترتب عن هذه الأزمة ستكون عميقة للغاية، وقد تنسحب على كل أوجه الحياة العامة والخاصة.
عالم ما بعد كورونا لن يكون كما قبله. يخبرنا تاريخ الأوبئة أن انكسار الإنسان أمام المرض، كان يُستتبع بانقلاب نوعي في المفاهيم والمعايير والأفكار والتصورات عن الذات والعالم. فكل جائحة، تاريخيًا، حملت بذور التغيير، ومهدت لعصر جديد. لم يزرع الطاعون الأسود، قديمًا، الموت فحسب، بل بذور التغيير أيضًا، وحين ساوى في الإصابة بين السيد والعبد، مهَّد لانتهاء عصر الرق. وبعد بضعة عقود من أسوأ موجات تفشي الوباء القاتل، أمكن تسجيل البدايات الأولى لعصر النهضة.
قبضة أقوى
وقد ينطبق الأمر ذاته على كورونا. وبدأت تتبلور الملامح الأولية للنتائج التي قد يسفر عنها الوباء، وأولها تقوية مفهوم الدولة المركزية، وتعزيز قبضة الحكومات. برهن الوباء أن الملجأ الوحيد، في أوقات الشدة، هو الدولة الوطنية المستعدة والقادرة، التي توظف قدراتها المالية والتنظيمية والإدارية في درء المرض. القطاع الخاص، تحركه الربحية، لن يوفر سريرًا في مستشفى لا يرتجى منه عائد ربحية. أما الدولة فعليها أن تفعل. يعاكس هذا الواقع اتجاهاً كان سائداً حتى أمس قريب، وقوامه تعظيم الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات العالمية والشركات العابرة للحدود والمؤسسات المعولمة في حل المشكلات بالتعاون وفتح الحدود وتمكين القطاع الخاص ورأس المال، وإزاحة العقبات من أمام المبادرات الفردية، وتهميش الدولة الوطنية. ومع ظهور كورونا، كان من المفارقات أن الطريقة الوحيدة التي سلمت كل الدول بأنها الأفضل لمنع تفشيه، تمثلت في انقلابها على مفاهيم ومبادئ الليبرالية وحرية السوق، وقيامها بغلق الحدود وتعطيل التنقل الدولي وعزل المدن وحجز الناس في منازلهم وإجبارهم على عدم مغادرتها إلا بإذن معلل.
كذلك، كان لافتًا للانتباه أن الأنظمة المتشددة بدت أقدر على حماية شعوبها من تفشي الفيروس، في حين أظهرت الأنظمة الديمقراطية في الغرب، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، تردداً غير مفهوم وغير مبرر في مواجهة المرض بداية، وحين تصرفت في النهاية، كان الأوان تقريبًا قد فات، على الأقل بالنسبة لمن قضوا نحبهم لغياب سرير شاغر في مشفى، ولا بد من الاعتراف أن الصين أظهرت في البداية بعض التراخي في مواجهة كورونا، وحاولت طمس بعض الحقائق المتعلقة به، ما ساهم في تفشيه. لكنها عادت لاحقًا فسخرت كل طاقاتها في مواجهته، وإذا أمكن إيجاد عذر للصين، كونها كانت تواجه مرضًا لا خبرة سابقة لأحد في مواجهته، فلا عذر لإخفاق بلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها في التصدي لكورونا، من منظور أنها تتربع على قمة الهرم الصحي العالمي، وتملك إمكانيات مادية ولوجستية هائلة، والأهم أن الصين قدمت للجميع علنًا دليلًا كاملًا لمواجهته.
هزات ارتدادية
سيترتب عن هذا الإخفاق هزات ارتدادية سياسية واجتماعية. فإذا كان من طبائع الناس أن يتحلقوا حول حكوماتهم في زمن الأزمات، إلا أن الوضع سرعان ما ينقلب إلى مساءلة مفتوحة لاحقًا. وسيتعين على الأحزاب الحاكمة والحكومات والإدارات المعنية في الغرب الديمقراطي الإجابة عن السؤال البديهي التالي: هل كان يعتقد، من أذن بتقديم الاقتصاد على الصحة، أنه يمكن فعلًا وضع العربة أمام الحصان؟
ولن تكون الصين وجسمها السياسي في منأى عن مثل هذه المساءلة، وقد عرى كورونا أوجه العطب الداخلي فيها. فمع كل تأخر من بيجينغ في الكشف عن المرض، كان ثمة المزيد ممن يدفعون الثمن الأغلى: حياتهم. وبدأت تعلو أصوات تشكك بالأرقام الرسمية ذات الصلة بوفيات كورونا، وبمدى انتشاره. كذلك، يأخذ الصينيون على قادتهم ما يسائل الغربيون قادتهم بسبب عدم تنفيذه: أي حجز الحريات بالقوة منعًا لتفشي كورونا. ففي النهاية، الجسم الطبي، لا الجيش، هو المسؤول الأول عن منع تفشي الأمراض.
كمامة مسيسة
بات واضحًا أن دحر كورونا ليست بالمهمة السهلة. ويتطلب ذلك تضافر كل الجهود على مستوى عالمي. في الولايات المتحدة، كان النقص في معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة وأجهزة التنفس حادًا جدًا، ما عرقل جهود إسعاف المرضى. وفي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، أجبر الأطباء على ترك المرضى لأقدارهم، لا بسبب عجز الطب، بل لافتقارهم إلى معدات لا تزيد كلفة تصنيعها عن بضعة آلاف من الدولارات. وثمة إصابات في صفوف الجهاز الطبي كان يمكن تفاديها لو زود أصحابها بأدوات الوقاية. لم تبدأ دول الغرب حربها ضد كورونا من موقع قوة. فهذه الدول ما زالت تنوء تحت أحمال أزمة 2008، التي تسببت بعجوزات ضخمة في الموازنة. لذلك، قد يترك الوباء أثرًا مستدامًا على النظام الاقتصادي. فحزم التحفيز التي تقر تباعًا، لا تأتي في أفضل توقيت، خصوصًا أن جروح أزمة الرهن العقاري لم تندمل بعد. وسيكون على المكلفين الضريبيين، في نهاية المطاف، تسديد الكلفة. أيضًا، وسواء تعلق الأمر بالأقنعة الواقية أو أجهزة التنفس أو الغذاء، فإن الوباء ولد نقصًا حادًا في المخزونات الوطنية، ومهد لحالة من التبعية سهلت تلقي مساعدات عابرة للحدود، ومسيسة في الغالب، باسم مواجهة التهديد المشترك، ولذلك أثمان.
يقود ذلك إلى النظر في طبيعة العلاقات بين الدول والشعوب. يصعب أن نحدد ما إذا كانت تأثيرات كورونا ستنعكس بالسلب أم بالإيجاب على العلاقات الدولية، لكن الثابت أن هذه العلاقات لن تعود إلى ما كانت عليه مطلع السنة. من المرجح أن تدفع تداعيات كورونا باتجاه خلق أشكال جديدة من المنظمات والمؤسسات الدولية. كان من ثمرات الحرب العالمية الأولى عصبة الأمم. ولما كنت أعجز من أن تدفع عن العالم ويلات الحروب الكبرى، انتهت الحرب العالمية الثانية بدفنها مع ما جرى دفنه آنذاك، وولدت الأمم المتحدة بشارة عصر جديد. ولن يضع العالم جائحة كورونا خلفه إلا بعد أن يضع معها أيضًا منظمات أممية أظهرت قصورًا حادًا في أن تقوم بالهدف الأول لوجودها: دفع التهديدات عنا جميعًا، بوصفنا مواطنين عالميين في وطن واحد هو الأرض.
التنين في جحر الخفاش
وقد تظهر العولمة كأبرز ضحايا كورونا. فلعقود، لم تدخر النخب والقيادات السياسية والمصرفية والاقتصادية جهدًا للتذكير بمنافع الليبرالية والعولمة وفتح الحدود. وكان لافتًا أن الدول الأكثر تبنيًا لهذه المفاهيم، كانت أول من أغلق حدودها فور ظهور المرض، في حين فرضت العديد من الحكومات الليبرالية قيودًا على السفر والتجارة أكثر قسوة مما قد تتجرأ أي حكومة وطنية على فرضه لتوطين الإنتاج. وبعد انتهاء جائحة كورونا، لن تكون هذه الإجراءات مستدامة، وسيرفع الكثير من القيود، إلا أن التجربة ستظل ماثلة، وعليها سيقاس في اتخاذ أي إجراءات مستقبلية لإنعاش الاقتصاد الراكد.
وكشفت الأزمة عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، فأعادت الاعتبار إلى عناوين من نوع الأمن الغذائي، والأمن الدوائي. ولا ينطبق ذلك على العالم النامي وحده. كان لافتًا أن تواجه البلدان المتقدمة نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية الضرورية. اكتشفت الولايات المتحدة، مثلًا، أن 97 بالمئة من مضادات الالتهاب تستورد من الصين. وستكون المهمة التالية لصناع القرار ضمان الأمن الغذائي والدوائي.
ماذا عن موازين القوة العالمية؟ هل حان أوان إعلان نصر الصين وهزيمة الغرب؟ فيما يجتاح كورونا العالم، توشك الصين على إعلان القضاء عليه محليًا، وتستعد للعودة إلى العمل. خلال ذلك، رسمت الصين صورة طيبة عن قدارتها، لكن على عكس الشائع، لن يسع الصين أن تخرج من معركة كورونا إلا بثوب ملطخ بالدماء، هذا إذا كنا سنفترض أن المرض حلبة مصارعة بين الأمم. فدول الغرب التي أعياها الفيروس، وبدا أنها تتسول المساعدات الطبية من الصين، ستنتبه فجأة إلى أن الاعتماد المفرط على الاستيراد، لا سيما في النواحي الاستراتيجية، قد يكون مكلفًا أحيانًا، وهو كان، في حالة كورونا بالتحديد، خياراً قاتلاً حرفيًا. في المقابل، لن يمثل الركود الاقتصادي المنتظر في أوروبا وأميركا نبأ سارًا للصين، التي ستكتشف سريعًا أن مستقبل عشرات ملايين الوظائف في البلاد لا يقررها الحجر الصحي الداخلي، بل المستهلك الغربي. وفي حين قد تشق بلدان الغرب طريق الخروج من متاهة الركود الاقتصادي المنتظرة بتزخيم الإنتاج المحلي، وفرض المزيد من القيود على التبادل التجاري، ستنكب الصين على تعزيز قدرات الاستهلاك الداخلي في سوقها الملياري، كبديل عن أسواق الغرب، مدخلًا للانتعاش. وللمفارقة، فإنها ستفعل بذلك، مجبرة، ما رفضت أن تفعله طوعًا منذ سنين طويلة، نزولاً عند مطالب شركائها التجاريين الغربيين.
حين دخلت الصين جحر الخفافيش، لم توقظ فيروسًا نائمًا فحسب، بل أيقظت كذلك خوفًا مضاعفًا من تعاظم قدراتها، قد يرتد عليها.
الأكثر قراءة
-
"أجيليتي للمخازن العمومية" الكويتية تسجل أرباحاً بقيمة 16.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025
-
"بورصة الكويت" توقف التداول على أسهم شركتي "عربي القابضة" و"المساكن الدولية للتطوير العقاري"
-
رياض سلامة بين الحرية المشروطة والخريطة القضائية المعقّدة
-
"هيوماين تشات": أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم في العالم
-
كيف تتحول "إنفيكتوس للاستثمار" إلى عملاق إفريقيا الغذائي؟